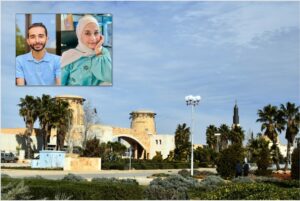د.نهلا عبدالقادر المومني
المطالبات بسن قانون للجرائم الإلكترونية كان مطلبا فرضته معطيات تشريعية وواقعية برزت في وقت مبكر خاصة عندما تم البدء في التحول نحو الحكومة الإلكترونية في الأردن.
في هذا السياق أذكر أنه وفي عام 2005م ناقشت أطروحة الماجستير والتي كانت بعنوان الجرائم المعلوماتية أو الإلكترونية وخلُصت الدراسة في حينه إلى توصية بضرورة تبني المشرع الأردني تشريعا يواكب الجرائم المستحدثة في الفضاء الإلكتروني أو الرقمي حيث كانت التشريعات القائمة في حينه تحاكي جرائم تقليدية بحتة الأمر الذي نشأ عنه ثغرات قانونية متعددة تبعها إفلات من العقاب بسبب قصور المنظومة الوطنية آنذاك.
في عام 2010م صدر أول قانون للجرائم الإلكترونية بصورة مؤقتة تحت مسمى قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت رقم 30 لسنة 2010. وفي حينه لم يثر القانون أي جدل يذكر حيث أنه كان يتعامل مع جرائم تقنية بحتة ويحيل إلى التشريعات القائمة في أي جريمة أخرى ترتكب.
في عام 2015م صدر القانون بصورته الدائمة، قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015م ليتضمن نصا يعاقب على الذم والقدح والتحقير بالوسائل الإلكترونية ومع بدء تطبيقات هذا النص بدأ الجدل يثور حول القانون والتوقيف على هذه الجريمة وتداعياتها.
في عام 2019م ردّ مجلس النّواب مشروع القانون المُعدّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة لسنة 2018م؛ وأثار بعض النّواب في حينه أنّ الأسباب المُوجبة لمشروع القانون كانت أسباباً شكليّةً. في عام 2023م تقدمت الحكومة بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، ليعود الجدل حول هذا القانون مجددا.
في ظل هذه المراحل التي شهدتها مسيرة هذا القانون يبقى السؤال الأهم كيف يمكن تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة، وفي الوقت ذاته إبقاء المبدأ الجوهري الذي تضمنه الدستور في المادة (128) خريطة طريق لأي تشريعات تستهدف التنظيم.
الوصول إلى قانون توافقي قادر على محاكاة الدستور الأردني الوثيقة الأسمى في المنظومة التشريعية الوطنية والمنسجم في الوقت ذاته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان يتطلب الأخذ بعين الاعتبار منطلقات أساسية قبل الخوض بتفاصيل النصوص ذاتها؛ وأول هذه المنطلقات أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون يقتضي أن تبرز مدى الحاجة الفعليّة له وأن تعكس وضوحاً في الفلسفة التي يقوم عليها التّشريع، وتبرز مكامن الخلل معززةً بالأرقام والإحصاءات مع قراءة هذه الأرقام قراءةً نوعيّةً قائمةً على أسس علمية منهجية سليمة، تعكسُ جلاءً في المصلحة المحمية بموجب القانون والتي تظهر ابتداءً من أسباب اتخاذ المشرّع قرار التّصدي لبعض الإشكاليات القائمة، وتحديد كيف سيُسهم مشروع القانون في معالجة إشكاليات المجتمع أو تطويره، وكيف سيُوازن بين حماية الحقوق أو الحرّيات وبين المصلحة العامّة، ويُبيّن ماهية الحق الأجدر بالحماية وكيف سيضع قيوداً تتّسم بالمشروعية وتبقى في إطار الاستثناء ملتزماً بالدستور وبالمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن.
أما الأمر الآخر فهو ضرورة البقاء في اطار السياسة التشريعية العامة التي لا تعمل على تكرار النصوص في قوانين متعددة تثقل بالنتيجة كاهل الدولة القانوني بنصوص مبعثرة تؤدي إلى إشكاليات في عملية التطبيق وتناقضات تشريعية في مسألة التوقيف وخلافه، والأولى تعديل التشريعات القائمة بما يضمن دقة الصياغة والابتعاد عن التأويل والتفسير إعمالا لمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة.
أما المنطلق الثالث فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن قانون الجرائم الإلكترونية جاء من حيث الأصل للتعامل مع الجرائم المستحدثة في الفضاء الرقمي سواء التي تقع على النظام المعلوماتي أو تلك التي تقع بواسطته إذا استدعى الأمر ولم تكن التشريعات القائمة كافية، فالوسيلة لا تعد عنصرا من عناصر ارتكاب الجريمة؛ لذا يتم وضع نص عام عادة في قوانين الجرائم الإلكترونية مفاده أن أي جريمة منصوص عليها في التشريعات الأخرى ترتكب بالوسائل الإلكترونية يعاقب عليها بالعقوبة المنصوص عليها في تلك التشريعات، ولا يحول ذلك دون اعتبار الوسائل الإلكترونية في بعض الجرائم الإلكترونية ظرفا مشددا تبعا لمعطيات متعددة منها حجم الانتشار وتأثيره.
وأخيرا هناك مسألة جوهرية لا بد من الوقوف عليها مطولا وهي أن الحلول التشريعية لا تعد دوما الطريق الأمثل لمعالجة إشكاليات مجتمعية قائمة، فالحاجة ملحة للتساؤل قبل تجريم نشر الأخبار الكاذبة حول مدى تفعيل بعض الأطر القانونية وتحقيق الانسياب في المعلومات وبناء الشخصية الإنسانية على التفكير الناقد والتربية الممنهجة عبر السياقات التعليمية المختلفة على عدم تقبل الأخبار أو المعلومات كحقائق والسعي دوما للبحث عن ماهيتها لتكون هذه التنشئة وتلك الانسيابية سدًا منيعا في ظل عالم متسارع الخطوات تكنولوجيًا أصبحت الأخبار الكاذبة فيه سمة أخرى للعصر.